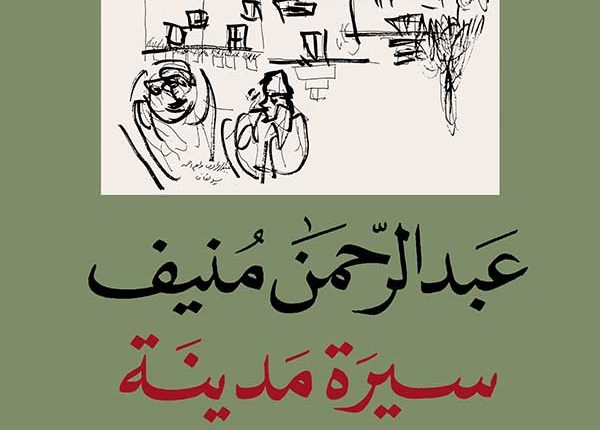رحلة مع عبد الرحمن منيف في “عمّان في الأربعينات”
بقلم : فاطمة صالح*
رافقت عبد الرحمن منيف، لعدة أيام، في (عمان في الأربعينات) طوينا خلالها ٤٣٦ صفحة.
لم يغرني كثيرا عنوان الرحلة، إنما أغراني اسم عبد الرحمن منيف، بالذات. وكنت قد رافقته فيما مضى، في بغداد، ومدن أخرى، من خلال “ثلاثية أرض السواد” و “شرق المتوسط” و “الآن هنا” وغيرها..
تجولنا في شوارع عمان التي كان أغلبها ترابيا، لم يعبد بعد، وبين بيوتها الطينية المتقاربة المبنية حول النهر، بين النباتات والأشجار المثمرة والخضرة الغناء. عشنا سنين قحط وانحباس الأمطار، رغم صلوات الاستسقاء، من الكبار والصغار. كما فاجأنا فيضان النهر، بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة المتواصلة، حيث غمرت مياه الفيضان بعض البيوت، وقضت على الحقول، وغمرتها بالطين، وهرب الناس نحو الجبال العالية “جبل عمان” اتقاء لغضب النهر الدافق، نمنا في البيوت الترابية تحت الدلف، ورأينا أصحابها يحدلون أسطحها الطينية بالمحدلة الصخرية المستطيلة، لتسد الشقوق التي يتسرب منها ماء المطر.
كما رأينا الجراد، وهو يشكل غيمة سوداء، تحجب الشمس، وتحط أسرابها السوداء على الأرض والأشجار الخضراء والنباتات، لتحيلها كلها جرداء خالية من الحياة.
اول الأمر، كنت أظن اننا سندخل إلى مدينة كبيرة ذات شوارع واسعة وبنايات عالية، لكنني فوجئت بعمان الأربعينات، أنها مكونة من عدة بيوت طينية، مبنية من طابق واحد، وحارات، وعدد من العائلات، أقرب ماتكون إلى القرية، منها إلى المدينة. كانت متنوعة السكان، كلهم يعرفون بعضهم، ويعيشون بمحبة وتآخ وتكافل وتعاون، كما فوجئت بالمهاجرين الشركس الذين بنوا بيوتهم في المدرج الروماني، او “مدرج فرعون” كما يدعوه البعض. وكانوا من أقدم سكان عمان، كانت الكنيسة والمسجد يتجاوران بعفوية ومحبة متبادلة وتكافل وإخاء .

كما تجمعت حولهما البيوت والمحال التجارية. دخلنا مدرسة “العبدلية” ، بعد أن زرنا “الكتاب”، واطلعنا على طريقة تدريسهم القاسية جدا للأطفال، ودخلنا أيضا كلية المطران والكلية الإسلامية التي درس فيها “الأمير” لبعض الوقت، قبل أن يغادرها إلى بلاد الغرب.
غضبنا مع السكان عندما رأينا الإنكليزي ( كلوب ) يسكن فوق تلة صخرية، تتيح له التجسس، ومراقبة مايجري في عمان، كانت كلابه تخيف الناس، أيضا، توجسنا مع المواطنين من ذلك الإنكليزي الدخيل، واحتقرنا معهم كل من يتقرب منه. وزع ( كلوب ) الأسلحة المتنوعة على ( البدو ) الذين استمالهم وتعاملوا معه، وجعل من مكان سكنه ثكنة عسكرية لتدريبهم، كان ذلك خلال الحرب الثانية. عشنا جوع الناس وفقرهم المدقع وقلة حيلتهم، وعشنا الأمراض التي فتكت بالكثير منهم، مثل ( التيفوس ) و ( الكوليرا ).
تعاطفنا مع الجدة العراقية التي كانت تعيش مع أسرتها في عمان، وتسافر، بين فترة وأخرى، إلى بغداد، وتعود، حاملة معها ماتيسر لها من مواد غذائية، وألبسة، ودفاتر وأقلام، توزعها على الناس، فخورة، أنها من بغداد. حتى أننا ضحكنا مع السكان على تصرفات بعض المجانين الذين يتجولون في الأسواق بأثوابهم الرثة الممزقة، وتصرفاتهم الغريبة، وكان الأطفال يستفذونهم، ليثيروا ضحكهم وتهكمهم، ومنهم ذلك الذي مات ابنه نتيجة ضربة شمس، فظل يقاتل الشمس، من طلوعها إلى غروبها، مهددا متوعدا، وعيناه لاتفارقانها دون أن ينظر أمامه.
ثم رأينا عمان وهي تكبر وتتسع، وتتوزع بيوتها على جبل عمان، وعلى التلال القريبة، وتتباعد البيوت وتتقارب بعشوائية، وقد بنيت من عدة طوابق بالإسمنت المسلح، خصوصا بعد انتهاء الحرب، وغدر الإنكليز، حيث كانوا يسهلون الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتسليحهم بمختلف أنواع الأسلحة الحديثة، وتدريبهم عليها، ويصمتون عن تهجير الفلسطينيين من ديارهم، وطردهم من أرضهم والتنكيل بهم، وقتلهم وإبادة قراهم ومدنهم، والاستيلاء على أراضيهم، من قبل اليهود الغرباء. عام 1948م. وقبلها.
فامتلأت عمان باللاجئين الفلسطينيين، واستقبلهم سكانها في بيوتهم، على الرحب والسعة، تعاطفوا معهم وساندوهم.
رأينا ثورة الناس في عمان، التي كان أغلب سكانها من فلسطين، وبعضهم من الشام، وتدافعوا للتطوع في جيش الإنقاذ، لمقاتلة اليهود الغاصبين، واسترجاع حقوق العرب الفلسطينيين منهم. خصوصا طلاب المدارس والجامعات، وبعضهم كان قد تخرج من جامعة دمشق أو بعض الجامعات العربية الأخرى، وعادوا إلى فلسطين والأردن، الذين هما بالأصل كيان واحد.
ثارة ثائرة الجميع، واحتد الغضب، والاندفاع. وقامت المظاهرات المنددة باغتصاب فلسطين، وامتدت هذه المظاهرات، واشتد حماس الناس لتحويل مافي صدورهم إلى قوة عملية لقتال الأعداء، لكن.. لكن العين بصيرة واليد قصيرة، فكيف يواجه العزل، أو الذين لديهم أسلحة بسيطة بدائية، كيف يواجهون غزاة متوحشين مسلحين بأحدث وأعتى أنواع الأسلحة التي زودتهم بها دول الغرب، خصوصا الإنكليز ؟!!
كما شاهدنا تلك المظاهرات تقمع بقسوة، دون أن يستطيع أحد منعها، جاءت بعض الجيوش النظامية من عدة أقطار عربية ومنها العراق، فاستبشر الجميع خيرا، وكم كانت الجدة سعيدة عندما زارها قريب لها جاء مع الجيش العرقي.! كانت فخورة بذلك ومستبشرة، لكن هذه الجيوش عادت من حيث أتت، دون أن تفعل شيئا، لكن ازدادت العمليات الفدائية والبطولات الفردية.. أصبنا بالإحباط كما الجميع، عندما رأينا أن كل ذلك لم يجد، وأن العدو قوي جدا بالأسلحة والعتاد، ولايعرف الرحمة، بينما كان الشعب فقيرا جدا، وأسلحته بسيطة، رغم حماسه الشديد، وتضحياته الكثيرة، لكن المعركة غير متكافئة، فمن أين نتغلب على الغاصبين؟ وكيف لنا استرجاع الحقوق.؟!
لكن عبد الرحمن منيف كان يقول أن لاشيء يستمر كما هو، ولاشيء في الكون ثابت، وكان متفائلا بالأجيال القادمة، التي ستغير المعادلة، وتقلب السحر على الساحر، وتعيد فلسطين من سالبيها.
كانت رحلتنا شيقة، رغم قساوة ماشاهدناه، وعشناه في “عمان في الأربعينات” لكن لاتتسع هذه العجالة لشرح كل مارأيناه.
وانتهت رحلتنا بعد وفاة الجدة في بغداد، ودفنها بين أقاربها وأهلها الذين سبقوها بالرحيل، حيث “خرج الحفيد من المقبرة إلى دوي المدينة، خرج إلى بغداد القاسية والحنونة، ليبدأ مشوارا جديدا في هذي الحياة !”.
—————————————
* أديبة وروائية سورية .