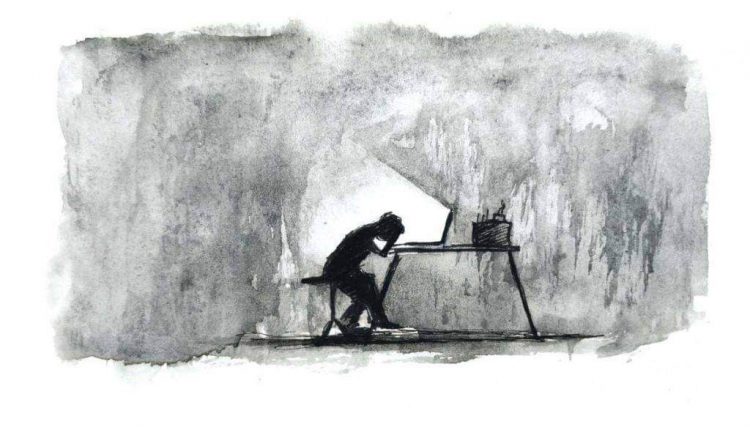الملل محفز نفسي نحن بحاجة إليه.. وقد يكون مصدراً للإبداع
“الدنيا نيوز” – دانيا يوسف
من وقت لآخر، يتسلَّل الملل بين ساعات نهارنا ليدخل حياتنا اليومية فيحيل كل ما فيها إلى ما يشبه السكون. وهذا الشعور يختلف تماماً عن الكآبة واللامبالاة، إلا أنه مثلهما: غير مرغوب به على الإطلاق. ولعل الأشهر الماضية من العام الجاري كانت من أكبر الفترات التاريخية التي اجتاح فيها الملل حياة الناس في معظم أرجاء المعمورة بسبب الحجر المنزلي في إطار مكافحة جائحة الكورونا.
ورغم أن الملل شعور رافق البشرية منذ قيامها، فإن محاولات دراسته علمياً تأخرت كثيراً عن الأدب، ولم تبدأ إلَّا في الألفية الثالثة.
تعود أول قصة تناولت المَلَل إلى حوالي أربعة آلاف سنة مضت، وقد كُتبت على ورق البردي في مصر الفرعونية، وتروي حكاية رجل ملّ من الحياة وأعبائها فقرَّر أن يقضي أيامه من دون أن يقوم بأي عمل ولا حتى أن يأتي بأي حركة منتظراً الموت، إلى أن ظهر له أحد الحكماء وشجَّعه على الاستمرار في الحياة والتمتع بها والبحث عن السعادة فيها. ومن ثم توالت الأعمال الأدبية التي تناولت المَلَل من جوانبه المختلفة حتى العصر الحديث.
فكانت مثلاً، رواية “مدام بوفاري” للروائي الفرنسي غوستاف فلوبير و”الغثيان” للفيلسوف والروائي جون بول سارتر، وكتاب أنيس منصور “وداعاً أيها المَلَل” الذي تضمَّن مجموعة من المقالات حاولت استكشاف المَلَل وما يُحدثه في النفوس، ورواية “إسطنبول” للكاتب التركي أورهان باموق وكلها تناولت المَلَل الوجودي الذي يمس وجود الإنسان.
ولعل أبرز الأعمال الأدبية التي حاولت استكشاف تاريخ المَلَل كشعور إنساني أزلي كتاب “المَلَل.. تاريخ حي” لبيتر توهي الذي يعود بنا إلى رسالة نُقشت على صخرة تعود إلى أواخر القرن الثالث في مدينة بنيفنتوم الرومانية تشهد لفضل شخص يدعى تانونيوس مارسيلونس في مساعدة سكان المدينة في التخلص من المَلَل. ويقول النقش: “بسبب الأعمال الصالحة التي قام بها تانونيوس مارسيلونس، الرجل صاحب السلطات القنصلية والراعي الأكثر استحقاقاً، حيث أنقذ سكان بنفينتوم من المَلَل الذي لا ينتهي، فإن الشعب بأكمله [في هذه المدينة] يحكم أن هذا الأمر يجب تسجيله في هذا النقش”.
وعلى الرغم من أن هوية تانيوس مارسيلينوس لم تعرف بالتحديد، ولا كيف أنقذ سكان مدينة بنفيتوم من المَلَل، إلَّا أن هذا النقش بقي ليذكرنا بالمَلَل الذي لطالما اعتبر بلاءً علينا التخلص منه، ومن ثقل تأثيره علينا. ومن ثم يتناول توهي مجمل الأفكار التي تناولت المَلَل من جوانبه المختلفه ومن حيث نوعيه الأساسيين: البسيط الذي يشعر به الإنسان عندما تطول فترة انتظاره في عيادة الطبيب مثلاً أو عند حضور محاضرة طويلة ثقيلة على النفس، والنوع الآخر المعقَّد والمزمن الذي يمس وجود الإنسان والذي سمَّاه بالمَلَل الوجودي وهو الذي تناوله كثير من الأعمال الأدبية والفنية، لكونه الأكثر تأثيراً على النفس البشرية.
آراء فلسفية عن المَلَل
لم يفلت المَلَل من نطاق تأملات الفلاسفة الكبار، وذلك لأنه ظاهرة متداخلة بعمق مع الحالة الإنسانية. فوفقاً للفيلسوف الوجودي آرثر شوبنهاور، فإن حياة الإنسان ، وحتى الحيوان “تتأرجح مثل البندول بين الألم والملل”، إذ إنه يرى أن الألم والملل هما المكونان الرئيسان للوجود، مما قد يُعدّ فكرة تقدِّم العزاء لكل من يشعر بالعزلة والمَلَل في ظل الإغلاق التي تفرضه علينا جائحة كورونا. ويمكن القول إن شوبنهاور كان أول فيلسوف غربي أخذ المَلَل على محمل الجد باعتباره من المآسي الأساسية للبشرية، وعرّفه بوضوح بأنه “توق دفين من دون أي هدف معيَّن”. ولم تختلف نظرة الفلاسفة الكبار عن هذه النظرة السلبية إلى المَلَل فأطلق عليه الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر “الضباب الصامت”، في حين وصفه الفيلسوف الدانماركي سورين كيركجارد بأنه: “جذر كل الشرور”.
مشاعر الخوف تساعدنا على تجنُّب الخطر، في حين أن الحزن يساعد في منع الأخطاء المستقبلية. وإذا كان هذا صحيحاً ، فما الذي يجب أن يحقِّقه المَلَل؟
بشكل عام، فإن محاولات الفلاسفة والأدباء والمفكرين تسليط الضوء على ظاهرة إنسانية طبيعية، بقيت قليلة نسبياً، قبل أن يأتي العلماء ليستكشفوا هذا الجانب المثير للفضول من الحالة الإنسانية، وتحديد الأسباب التي تدفعنا إلى هذا الجوع الفطري المفترض للتحفيز والترفيه والتفاعل مع شيء آخر غير عقولنا ووجودنا مع ذواتنا فقط.
فالدراسات الفعلية للملل لم تنطلق إلا مع الألفية الثالثة وهي لا تزال في بداياتها. وقد كتب الكاتب والمحرر في مجلة “المفكِّر الأمريكي” جوزيف إبشتاين أن: “المَلَل هو، قبل كل شيء، جزء من الوعي. وفي ما يتعلق بالوعي، لا يزال لدى أطباء الأعصاب كثير ليطلعونا عليه أكثر مما أخبرنا به الشعراء والفلاسفة”.
وفي هذا الإطار، أُجريت تجارب واختبارات كثيرة توصَّلت إلى نتائج حدَّدت جوانب متنوِّعة لظاهرة المَلَل. فمنها ما وجد أن المَلَل يمكن أن يحدث لدى البشر إما بسبب قلة المعلومات أو بسبب كثرتها. ومنها ما خلص إلى أن أولئك الذين يعانون من ضعف في قدرة الانتباه يشعرون بالمَلَل بسهولة أكبر، تماماً كما أولئك الذين يبحثون دائماً عن الإثارة. وأن الأشخاص في منتصف العمر هم أقل عرضة للمَلَل من المراهقين وكبار السن. وبعضها وجد أن الرجال أكثر عرضة للشعور بالمَلَل من النساء، وأنه حتى الحيوانات يمكنها أن تشعر بالملل، وذلك من خلال دراسة وجدت أن حيوان المنك الأسير في بيئات غير مثيرة يُظهر مؤشرات تدل على الشعور بالملل.
ولعل أبرز هذه الدراسات تلك التي اكتشفت أن الناس قد يذهبون إلى حد التعرُّض لصدمات كهربائية مؤلمة لمجرد تجنب الملل. ففي دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2014، تُرك عدد من الأشخاص بمفردهم في غرفة بيضاء هادئة لا يوجد فيها أي شيء سوى زر واحد كانوا يعلمون أنه في حال ضغطوا عليه سيصيبهم بصدمة كهربائية. بعد بضع دقائق، شعرت نسبة كبيرة منهم بالملل إلى درجة أنهم ضغطوا على الزر، وتلقوا الصدمة، حتى إن بعضهم ضغط عليه مرتين. وما دلت عليه هذه الدراسة هو أن الأشخاص يفضلون أن يتلقوا حافزاً ضاراً على عدم تلقي أي منبه على الإطلاق، أي بعبارة أخرى يحاولون تجنب الملل مهما كان الثمن.
وتجنب الملل سمة دائمة ترافق البشر، وقد أصبح الأمر أسهل في عصرنا الحالي الذي تقوده التكنولوجيا، حيث تحوَّلت الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى مسكّنات للملل ووسائل سهلة لإحياء الفضول. ولكن النتيجة أننا تحوَّلنا معها إلى أشخاص مدمنين نواصل البحث عن محفزات أسرع وأسهل ولكنها لا تؤدِّي في النهاية إلا إلى مزيد من الملل، حتى أصبح الأمر يشبه ما أشار إليه شوبنهاور عندما قال إن: “هذا هو المصدر الحقيقي للملل؛ اللهاث المستمر خلف الإثارة، من أجل الحصول على ذريعة لإعطاء العقل شيئاً يشغله”.
هل يجب علينا تجنُّب المَلَل؟
ولكن محاولة البشرية تجنب الملل تمثل لغزاً لعلماء النفس التطوريين. إذ إن العواطف، بطبيعتها، غالباً ما تتطوَّر لصالحنا، وليس لدفعنا إلى تدمير الذات. وهي موجودة لمساعدتنا على تسجيل وتنظيم والتفاعل مع المحفزات التي نتلقاها من البيئة المحيطة بنا. تقول الدكتورة هيذر لينش، الأستاذة في “جامعة تكساس إيه آند إم: “إن كون الملل تجربة يومية يشير إلى أنه يجب أن يقدِّم لنا شيئاً مفيداً”.
فمشاعر الخوف تساعدنا على تجنب الخطر، في حين أن الحزن يساعد في منع الأخطاء المستقبلية. وإذا كان هذا صحيحاً، فما الذي يجب أن يحققه الملل؟ تقول لينش: إن الملل يشجِّع عقولنا على الشرود ويدفعنا إلى محاولة البحث عن أهداف جديدة أو استكشاف مناطق أو أفكار جديدة. وهذا ما يجب على الملل أن يقوم به بالتحديد.
فمع غياب أي تحفيز خارجي، علينا أن ننظر داخلياً لنذهب إلى أماكن مختلفة في أذهاننا، وهكذا يمكننا تحقيق قفزات في الخيال والخروج من الصندوق والتفكير بطرق مختلفة. وهنا بالضبط يتحقق الإبداع الذي من دونه لما تمكنا نحن البشر من تحقيق كل هذه الابتكارات الفنية والتكنولوجية التي توصلنا إليها.
يقول جون إيستوود، الأستاذ في “جامعة يورك” الذي شارك في وضع كتاب جديد عن الملل بعنوان “خارج جمجمتي”: “إن الملل ليس في حد ذاته إبداعاً، ولكن يمكنه أن يكون مصدراً للإبداع. فعندما نشعر بالملل نكون في حالة غير مريحة ويكون لدينا الدافع إلى البحث عن شيء آخر. وهنا، في هذا الدافع، توجد فرصة حقيقية لاكتشاف شيء جديد”.
ماذا لو أصغينا إلى الملل؟
بدل تجنب الملل، ربما يكون الخيار الأمثل هو الإصغاء إليه والترحيب به. لأنه يمكن للملل أن يعمل كمحفِّز نفسي نحن بحاجة إليه، ويمكنه أن يهيئ الفرصة لقدوم لحظة مضيئة ننتظر مجيئها منذ فترة. فلنستجب لتوجيهات الملل ولا نحصن أنفسنا ضده لأنه كما يقول فريدريك نيتشه: “إن الذي يحصِّن نفسه تماماً ضد الملل يحصِّن نفسه ضد نفسه أيضاً. إنه لن يشرب أبداً إكسيراً أقوى من نبعه الداخلي الخاص”.
وهناك أمثلة عديدة عن مبدعين كبار وجدوا في الملل فرصة لكي يشربوا “إكسيراً” قوياً من نبعهم الداخلي الخاص. ففي مقابلة لها مع الإذاعة البريطانية عام 1955م قالت الروائية الشهيرة أغاثا كريستي أنه: “لا يوجد شيء يضاهي الملل يدفعنا إلى الكتابة”. فأغاثا كريستي، لم تحصل على تعليم رسمي إلى أن بلغت السادسة عشرة من عمرها، لذلك كان لديها كثير من الوقت لتقضيه وحدها وهي تشعر بالملل. فوجدت طرقها الخاصة للترفيه من خلال الكتابة، حتى إنها عندما بلغت سن السادسة عشرة كانت قد كتبت عدداً كبيراً من القصص القصيرة ورواية طويلة واحدة. ويؤكد الروائي البريطاني نيل غيمان أهمية الملل في مسيرته الإبداعية أيضاً، فيقول: “عليك أن تدع نفسك تشعر بالملل إلى درجة أن عقلك لن يكون لديه ما يفعله أفضل من سرد قصة لنفسه”. ولكن ليس الكتَّاب وحدهم هم الذين وجدوا الملل جزءاً مفيداً من العملية الإبداعية. فقد قال النحات الشهير أنيش كابور: “لقد تعلَّمت على مر السنين أنه بالضبط في تلك اللحظات التي لا أعرف فيها ماذا أفعل، يدفعني الملل إلى المحاولة“.